
تكشف دراسة جديدة للباحث بوشتى المشروح سياسة الدعاية السينمائية للاحتلال الفرنسي بالمغرب زمن “الحماية”، وما يرتبط بها من رقابة قبلية وبعدية، في أحدث أعداد الدورية المغربية المحكمة “ليكسوس” المتخصصة في التاريخ والعلوم الإنسانية.
ومن بين ما كشفته الدراسة “تشدد سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب في مراقبة الأفلام السينمائية المصرية قبل وبعد عرضها؛ فبعد التأشير على عرضها، كان يقوم بعض موظفيها بتسجيل ردود أفعال الجمهور خلال العرض، ما كان يتيح لها إعادة مراقبة الفيلم وحذف بعض مشاهده أو منعه من العرض”، ثم قدم المصدر مثالا بعرض فيلم “الجنرال لاشين” حيث “سجل أحد موظفي الإقامة العامة، تفاعل المتفرجين مع مشهد الفلاح الذي تحدث عن استعداده للموت من أجل أرضه الفلاحية، باعتبارها وطنه، حيث كان تصفيق الجمهور على الكلمات التي نطقها الفلاح كافيا لسحب الفيلم من التوزيع، ومنع عرضه بالقاعات السينمائية التي برمجته”.
وذكرت الدراسة أن “سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب” سنت “قوانين جديدة” بعد توقيع عقد الحماية سنة 1912 من أجل “تنظيم قاعات العرض السينمائي، وتعزيز الرقابة على الأفلام، لتسهيل عملية ضبط المجتمع المغربي ومراقبته، سواء في المدن، أو في البوادي، حيث كانت فئات من السكان القرويين تشاهد عبر القوافل السينمائية أفلام البروباغاندا التي كانت تمجد الدولة الحامية وما كانت تقوم به. ومن جهة أخرى، أسهمت السينما في تنمية موارد الدولة الحامية، من خلال سنها لضرائب تقتطع من مبالغ التذاكر التي كان المتفرجون يقتنونها، وتوزع على البلديات، علاوة على إسهام ضريبة الفقراء في تنفيذ برامج اجتماعية لفائدة عائلات وذوي الجنود الذين أصيبوا أو قتلوا خلال المواجهات الحربية”.
ويتابع المصدر: “توافدت مجموعة من المخرجين السينمائيين على مناطق من المغرب، بغية تصوير أفلامهم السينمائية، التي رسخت النظرة الغرائبية، والعجائبية، والاستشراقية في ذهن المشاهد الأوروبي، وقدمت صورة سلبية عن المجتمع المغربي، فيما قدمت الأوروبيين في صورة المتحضرين الذين أتوا إلى المغرب لنشر حضارتهم وقيمهم”.
واستشهدت الدراسة برسالة المقيم العام للاحتلال الفرنسي بالمغرب ليوطي، المؤرخة في 30 دجنبر من سنة 1920، التي من بين ما تضمّنته: “لا يمكننا أن نشك في النتائج السارة التي يحق لنا أن ننتظرها من جهاز العرض السينمائي كأداة تعليمية لتربية محميّينا، وبكل تأكيد فالأفلام المناسبة ستترك في عقول المغاربة آثارا عميقة حول قوة وحيوية فرنسا، بل من الممكن أن تتولد لديهم الرغبة في تحسين أوضاعهم، بعد إجرائهم لمقارنات متكررة بين أساليبنا وأساليب عملهم التي عفا عنها الزمن، لذا وجب علينا أن نعمل على تحقيق رغبتهم وفق المخطط الذي أعددناه، ودون إحداث اضطراب في العادات التي يرتبط بها المغاربة بشدة. يمكننا بالسينما أن نغرس في نفوس محميينا الإعجاب بفرنسا، الأمر الذي سيزيد من ثقتهم بنا”.
في سياق هذه الرؤية “شهدت المدن المغربية الكبرى مثل فاس، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش، ووجدة إقامة عروض سينمائية في المقاهي والحانات والفنادق وغيرها.
وعادت الدراسة إلى قرار وزيريّ صدر بتاريخ “22 أبريل من سنة 1916، نص على ضرورة الحصول على رخصة من الإدارة المحلية الممثلة للحكومة، وضرورة توفر محل عرض الأفلام السينمائية على شروط السلامة، واعتماد التيار الكهربائي وسيلة وحيدة للإضاءة وتشغيل العرض، إضافة إلى التنصيص على منع عرض الصور والأفلام المخلة بالمروءة والنظام العام”.
واسترسلت قائلة: “فرضت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب رقابة على العروض السينمائية من خلال إصدارها لقرار يتعلق بتنظيم مراقبة الأفلام السينمائية، حيث نص القرار على منع استيراد أي فيلم أو تصويره داخل مناطق الحماية الفرنسية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المكلفة بالمراقبة، واستثنى الترخيص الأفلام التعليمية والتهذيبية. كما أحدث هذا القرار لجنة رقابية أوكل لها مهمة مراقبة الأفلام ومنعها، وإعطاء تأشيرات لعرض الأفلام التي تراها صالحة للعرض، مع تهديد المخالفين بغلق قاعاتهم السينمائية. وتضمن القرار نفسه إلزام مستوردي الأفلام بتقديم بيانات خاصة عن الفيلم المستورد وإلزامية إدخال الأفلام إلى المغرب عبر مدينتي وجدة والدار البيضاء فقط، حيث أوكلت للجنة الرقابة بالمدينتين صلاحية رفض أو منح تأشيرة دخول الأفلام إلى المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية بالمغرب”.
وبالاستناد إلى وثائق رسمية لـ”الحماية الفرنسية”، تتحدث الدراسة عن عمل “سلطات الحماية بعد انتشار القاعات السينمائية في معظم المدن المغربية، على نقل الفرجة السينمائية إلى القرى”، معلنة أن “هدفها هو تثقيف وتوجيه وتربية الفلاح والراعي، في حين أن غايتها غير المعلنة كانت استخدام السينما أداة لاختراق القرى المنغلقة على نفسها، من أجل ضبطها، ومراقبتها”.
في بداية العرض السينمائي “يقوم منشط العرض بإدخال الجمهور في أجواء العرض السينمائي، ويعرّف بمضامينه، ويذكر أسماء الشخصيات الحاضرة لتأطيره، ثم يعرض فيلما وثائقيا مصحوبا بتعليق هزلي باللهجة المحلية، يتضمن مشاهد من الحياة اليومية للمغاربة، وأماكن وشخصيات يعرفها المشاهد، ليتأكد أن هذا النوع من الأفلام يقدم حياة حقيقية وواقعية وغير مصطنعة، يليه عرض فيلمين تختلف مواضيعهما حسب المناطق والجهات، ويتناول مضمونهما الصناعة التقليدية أو الزراعة وتربية المواشي، أو مظاهر العصرنة والتحديث، أو تشييد السدود، أو النظافة والصحة العامة. وكانت تعتبر هذه المرحلة الأهم في العروض السينمائية، لأنها كانت ترسخ لدى المشاهد القيم والأفكار التي سعت سلطات الحماية الفرنسية إلى غرسها لدى المشاهد. ولضمان تحقق ذلك، كان يعاد عرض الفيلم نفسه لاستهداف شرائح كثيرة من المتفرجين، ومنح الوقت لهم لفهم مضامين الفيلم”.
كما ذكر المصدر أن “الميكرفون كان أهم أداة في العرض السينمائي، حيث حل مشاكل متعددة واجهتها مصلحة السينما، من بينها استحالة توفير نسخ من أفلام مدبلجة إلى اللهجات المحلية، حيث كانت تقدم نفس الأفلام في مناطق متعددة ومختلفة اللهجات. ولذلك عمدت مصلحة السينما إلى تقديم نسخ بدون حوار أو تعليق، وتكليف شخص بمهمة التعليق وترجمة مشاهد الفيلم للمتفرجين حسب لهجتهم المحلية”.
لكن لم يقتصر عمل “سلطات الحماية” في المجال السينمائي على تنظيم الفرجة السينمائية ومراقبتها، بل امتد إلى “تشجيع إنتاج الأفلام الكولونيالية، حيث صوّر أول فيلم طويل بالمغرب، حمل عنوان: (مكتوب) سنة 1919، أعقبته أفلام أخرى حاولت إبراز الطابع الغرائبي والعجائبي والاستشراقي حول المغرب، وعكست صورة المغرب والمغاربة التي ترسخت في ذهن بعض الفرنسيين، حيث أظهرت مناطق من المغرب فضاءات متخلفة، تحتاج إلى البناء والتحديث والتطوير، وصورت فئات من المغاربة كجماعات غير مترابطة، يكثر بينها الصراع والقتال”.
وواصلت الدراسة: “قدم مخرجو الأفلام الكولونيالية الفرنسية ممثلي سلطات الحماية كأشخاص متحضرين، كانوا يعملون على تحديث المجتمع المغربي وتطويره. كما صوروا أفرادا من كتائب الجيش الفرنسي كمتدخلين لإحلال السلم والأمن وتعقب المتمردين، علاوة على تقديمها لمشاهد بعض الأطباء العسكريين يقدمون العلاج للجرحى من صفوف المغاربة الذين واجهوا بعض كتائب الجيش الفرنسي، في محاولة لتجميل صورة أفراد الجيش الفرنسي في أعين المغاربة، وتقريب الهوة بينهم وبين سلطات الحماية الفرنسية، والترغيب في التعامل بينهما”.




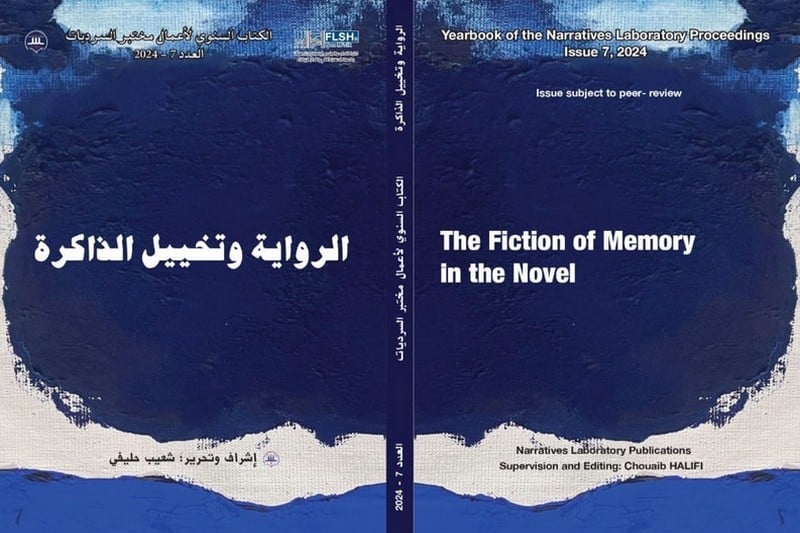






تعليقات
0